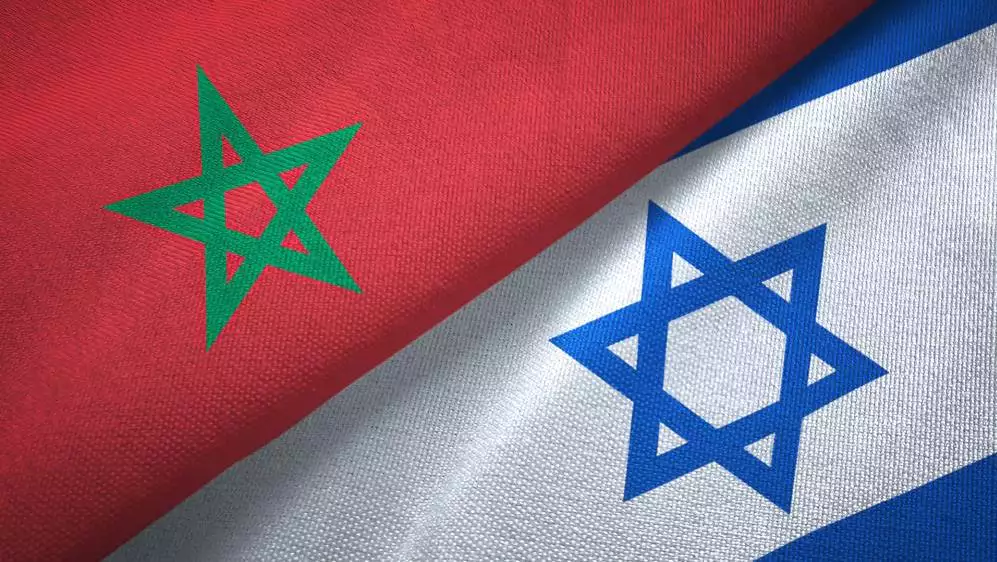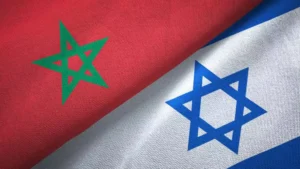فيصل مرجاني
إن التاريخ الأمني للدول لا يكتبه التوقيع على الاتفاقيات، بل تُعيد صياغته تلك اللحظات الصامتة التي تتغيّر فيها العقائد، وتُفكَّك فيها المسلّمات، ويُعاد تعريف معنى التهديد والردع والبقاء. وفقا لهذا المنظور، يصبح من الخطأ المنهجي التعامل مع بعض الشراكات الجديدة كوقائع دبلوماسية عادية، لأنها في الحقيقة تمثل انتقالًا من منطق إدارة المخاطر إلى منطق هندسة القوة.
وبناء على ذلك، لا يعتبر التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي الدفاعي مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية، بل يشكل لغة سيادية رئيسية مكتملة، تعبّر عن كيفية إدراك الدولة لمحيطها، ولمستقبل صراعاتها، ولموقعها داخل خرائط النفوذ الإقليمي والدولي، فعندما تختار دولة ما أن تعيد بناء أمنها عبر أدوات غير تقليدية، وعبر شراكات عالية الحساسية، فإنها لا تبحث عن حماية آنية، بل عن إعادة تموضع طويل الأمد داخل معادلات الردع.
وفقا لهذا الأساس، لا يمكن قراءة مقاربة التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي الدفاعي بين المغرب وإسرائيل من زاوية الاتفاقيات المعلنة أو الزيارات البروتوكولية، لأن ما تم اعتماده بداية من سنة 2020 يشكل بنية تعاون وظيفي عميق، أقرب إلى الاندماج العملياتي المحدود منه إلى شراكة تقليدية بين دولتين، لأن هذا التعاون لا يُقرأ بوصفه نتيجة ظرفية سياسية معينة، بل كتحول بنيوي في عقيدة الأمن القومي المغربي، وفي تموضع إسرائيل داخل المجال الاستراتيجي لشمال إفريقيا وغرب المتوسط.
لقد كانت لحظة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، تجسيدا لعملية الانتقال مباشرة إلى المستوى القوة الصلبة من حيث مجالات التعاون، والتي تمثلت في: الدفاع، الاستخبارات، التكنولوجيا العسكرية، والسيادة السيبرانية. والذي بدأت معه عملية انتقال غير مألوفة ضمن العلاقات الدولية، إذ تم من خلال هذا التحول تجاوز المراحل الرمزية والدبلوماسية، والدخول مباشرة في منطق الأمن الصلب Hard Security، ما يدل على وجود تنسيق مسبق، أو على الأقل تصورات استراتيجية متقاطعة كانت جاهزة للتفعيل فور رفع القيود السياسية.
وغني عن البيان، بأن المعلومات المتقاطعة الصادرة عن دوائر الصناعات الدفاعية، ومراكز أبحاث أمنية غربية، أكدت أن التعاون المغربي–الإسرائيلي لا يقوم على منطق “الشراء” فقط، بل على نقل معرفة، وتوطين تكنولوجيا، وبناء قدرات ذاتية طويلة الأمد، برزت معه ضرورة إدماج منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، وتطوير قدرات الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والاستخبارات، وهذه كلها عناصر تشير إلى أن المغرب لا يسعى إلى تفوق آني، بل إلى إعادة تشكيل ميزان الردع الإقليمي وفق منطق استباقي، وليس تفاعلي.
في الواقع، لا بد لنا من الإشارة هنا بأن إسرائيل لا تصدّر السلاح كسلعة فقط للمغرب، بل تصدّر عقيدة تشغيل، ونموذجًا استخباراتيًا قائمًا على الدمج بين المعلومة، القرار، والتنفيذ في زمن قياسي، كما أن اعتماد المغرب لهذا النموذج، وتكييفه مع خصوصياته الجيوسياسية، يعني عمليًا الانتقال من نموذج دفاعي تقليدي إلى نموذج شبكي Network-Centric Warfare، حيث تتكامل الأقمار الصناعية، الطائرات المسيرة، الرادارات، ووحدات التدخل السريع ضمن منظومة نموذجية.
كما أن الأهم في هذا التعاون كونه يُدار خارج الضجيج الإعلامي، وبمنطق “الحد الأدنى من الإعلان والحد الأقصى من الفعالية”، لأنه سلوك يدل على إدراك الطرفين لحساسية البيئة الإقليمية، خاصة في ظل سباق تسلح غير معلن في شمال إفريقيا، وتداخل المسارات والمصالح بين الفاعلين الدوليين والإقليميين. وعليه، فالتكنولوجيا الإسرائيلية التي يتم إدماجها في المنظومة المغربية ليست موجهة فقط لمواجهة تهديدات كلاسيكية، بل لمجابهة سيناريوهات هجينة: حرب معلومات، اختراق سيبراني، طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، وشبكات دعم غير نظامية.
وضمن سياق أعمق، يشكّل المغرب بالنسبة لإسرائيل منصة جيوأمنية متقدمة خارج نطاق الشرق الأوسط التقليدي، تسمح لها بتوسيع مجالها الاستراتيجي نحو الأطلسي وإفريقيا، دون الانخراط المباشر أو المكشوف. كما أنه في مقابل ذلك، يستفيد المغرب من خبرة إسرائيل في تحويل التهديدات الوجودية إلى محركات للابتكار العسكري والتكنولوجي، وهو ما ينسجم مع رؤية مغربية تسعى إلى تقليص الفجوة النوعية مع الخصوم، بدل الدخول في سباق كمي مُكلف وغير مضمون.
على جانب آخر، يعتبر التعاون الاستخباراتي، رغم غياب المعطيات الرسمية، أحد أكثر مستويات الشراكة عمقًا، فالتنسيق في مجالات تحليل البيانات، الاستخبارات التنبؤية، والرصد متعدد المصادر، يعكس انتقالًا من منطق “الأمن بعد الحدث” إلى منطق الأمن قبل التهديد، فهذا التحول بالذات هو ما يمنح هذا التعاون طابعًا استراتيجيًا لا تكتيكيًا.
وتبعا لذلك، يصبح التعاون المغربي–الإسرائيلي جزءًا من هندسة أمنية جديدة في المنطقة، لا تقوم على التحالفات الإيديولوجية، بل على تقاطع المصالح الصلبة، وإدارة المخاطر، وبناء التفوق النوعي. ويدل كل هذا على تعاون لا يستهدف الاستقرار الظاهري فقط، بل يسعى إلى فرض معادلة ردع طويلة المدى، تجعل كلفة أي مغامرة معادية مرتفعة سياسيًا وعسكريًا وتقنيًا.
عموما، إن ما يجري بين الرباط وتل أبيب ليس مجرد تعاون ثنائي، بل إعادة برمجة لمعادلات القوة في شمال إفريقيا، باستخدام أدوات القرن الحادي والعشرين: التكنولوجيا، الاستخبارات، والردع الذكي. ومن يقرأ هذا المسار بمنطق سطحي، أو أخلاقي، أو إعلامي، يفوته جوهر المسألة: نحن أمام نموذج جديد لدولة إقليمية تبني أمنها عبر العقل، وليس الضجيج، وعبر الشراكات الدقيقة، وليس الاصطفاف وراء الشعبوية.
فعلاقة بالمستوى التقني الصرف، فإن ما يمنح هذا التعاون المغربي–الإسرائيلي قيمته الاستراتيجية الحقيقية هو اندراجه ضمن منطق C4ISR المتقدم (القيادة، السيطرة، الاتصالات، الحواسيب، الاستخبارات، المراقبة والاستطلاع)، حيث لم يعد السلاح يُقاس بمداه أو قوته النارية فقط، بل بقدرته على الاندماج داخل شبكة عملياتية موحّدة تُنتج القرار في الزمن الحقيقي، بحكم أن المؤشرات المتقاطعة تفيد بأن المغرب انتقل من نموذج منصات مستقلة إلى نموذج منظومات متشابكة، وهو انتقال لا يتم إلا عبر شراكة مع فاعل يملك خبرة تشغيلية فعلية في بيئات تهديد عالية الكثافة، وهو ما يفسر الثقل الإسرائيلي في هذا المسار.
أما على مستوى مجال الدفاع الجوي، لا يتعلق الأمر فقط باقتناء منظومات متعددة الطبقات، بل ببناء هندسة ردع جوي متكاملة قادرة على التعامل مع تهديدات غير متماثلة: طائرات مسيّرة منخفضة البصمة، ذخائر جوالة، صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وهجمات إغراق Saturation Attacks، بحيث أن إدماج هذا النوع من الأنظمة يفرض إعادة صياغة عقيدة الانتشار، والربط بين الرادارات الأرضية، وأنظمة الإنذار المبكر، ووحدات الاعتراض، ضمن تصور عملياتي قائم على الاستباق لا الردّ.
بينما ضمن مجال الطائرات المسيرة، فالتعاون يتجاوز الاستخدام التكتيكي إلى بناء عقيدة Drone-Centric Operations، حيث تصبح الطائرات المسيّرة جزءًا من سلسلة القتل Kill Chain، من الرصد إلى التحييد، مع قابلية العمل في بيئات مشوشة إلكترونيًا، لأن هذا النوع من القدرات لا يخدم فقط الردع العسكري، بل يعزز التفوق الاستخباراتي، ويقلص هامش المفاجأة الاستراتيجية لدى الخصوم.
أما على مستوى الفضاء السيبراني، تتقاطع المعطيات حول اعتماد مقاربة هجومية–دفاعية مزدوجة، تقوم على حماية البنى الحيوية، كما أنه في الآن ذاته تمكن من امتلاك قدرات تعطيل، اختراق، وتضليل عند الضرورة، ويكون معه هذا البعد تحديدًا هو الأكثر حساسية، لأنه يخرج الأمن من المجال العسكري الكلاسيكي إلى مجال السيادة الرقمية، حيث تصبح المعركة غير مرئية، ولكن نتائجها حاسمة.
غير أن اللافت هنا مرتبط بأن هذا البناء التقني يتم دون استعراض، ودون سباق تسلح صاخب، ما يدل على أن الهدف ليس خلق ردع إعلامي، بل تفوق صامت Silent Superiority، وهو النموذج الذي تبنته إسرائيل تاريخيًا، ويبدو أن المغرب يستوعبه ويكيّفه مع محيطه الاستراتيجي، فالتفوق هنا لا يُقاس بعدد المنصات، بل بمرونة المنظومة، وقدرتها على امتصاص الصدمات، والتكيّف مع سيناريوهات غير متوقعة.
مما يجسد هنا، المكانة الكبرى للتعاون المغربي–الإسرائيلي كنموذج لما يمكن تسميته بالردع الذكي Smart Deterrence: ردع لا يعتمد على التهديد العلني، بل على خلق حالة عدم يقين دائم لدى الخصم حول قدرات الرصد، وسرعة القرار، ونطاق الرد الممكن، وهذا أخطر أشكال الردع وأكثرها فعالية